تتبادر إلى الأذهان العديد من الصور المروّعة خلال حقبة الحرب الباردة في فترة الخمسينات من القرن الماضي، ليس أقلها بشاعة مشاهد أطفال المدارس وهم يزحفون تحت مقاعدهم للاحتماء من انفجار قنبلة ذرية. إضافة إلى ذلك، كانت هذه الحقبة مهددة بحدوث حرب نووية محتملة بين أميركا وحليفها الشيوعي، آنذاك، ممثلا بالاتحاد السوفيتي. ولعل أقل ما شغل بال المواطنين الأمريكيين في تلك الفترة هو إمكانية وقوع هجوم من قبل العدو باستخدام السلاح الكيميائي أو البيولوجي، عبر تلويث مياه الشرب أو نثره في الهواء مثلاً.
كانت طمأنينة الأمريكيين ناتجة عن موقف القوات العسكرية الأمريكية المُشكلة حديثاً، بشقيها سلاح الجو الأمريكي وجيش الولايات المتحدة، والذي وقف مجابها ضد أيّ هجوم من هذا النوع، أو أقله هكذا بدا الأمر. أظهرت العديد من الدراسات التي كشف عنها في العقد الأخير أن الولايات المتحدة وحليفتها الأبدية، المملكة المتحدة، ركزتا بالفعل على الاستخدام الهجومي للأسلحة البيولوجية والكيميائية، كما أسست الدولتان الحليفتان العديد من البرامج لتطوير وتحسين قدراتهم الهجومية في هذا المجال.
أدركت الدولتان، الأمريكية والبريطانية، أن الاستخدام الأمثل للأسلحة البيولوجية يتطلب بالضرورة نشر المواد السامة في البيئة الطبيعية المحيطة، مما يعني فعالية أعلى في نتائجها، فمثلاً يمكن استغلال الظروف الجوية القاسية لنشر السم في الهواء على مساحات واسعة، واستهداف المنطقة المقصودة ضمن هذه العملية. هذا الهجوم يستدعي دراسة ظروف نشر السم في مناطق العدو والقيام بمحاكاة مسبقة قبل الضربة، وبالتالي احتاجت الولايات المتحدة إلى ظروف جوية مشابهة لتلك الموجودة في أراضي الأعداء. بمعنى آخر، لو أرادت الولايات المتحدة أن تنشر السم في مدينة روسية مثل «كيركوز»، ستجد مدينة أمريكية بظروف جوية مشابهة، من حيث نفس نمط الرياح، ونفس الكثافة السكانية، لتستخدمها في محاكاتها كي تحدد فيما إذا كان الهجوم الكيماوي فعالا أم لا، وقد كانت مدينة «سانت لويس» مكان الحدث لتلك التجربة.
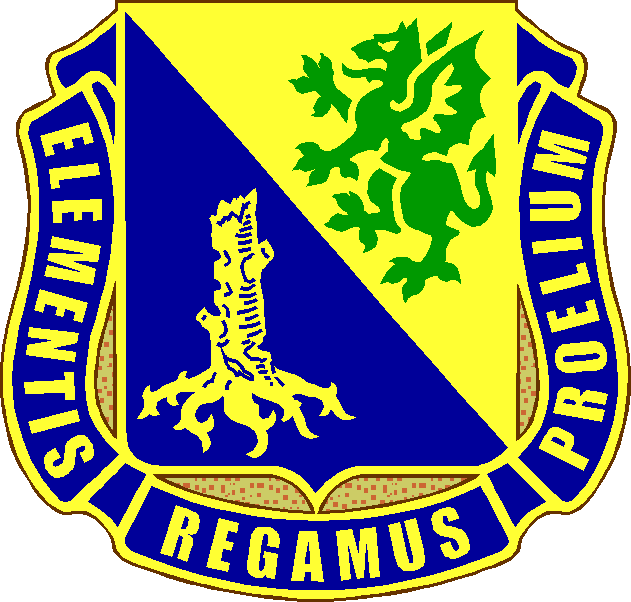
اجتمعت دول العالم، بعد استخدام الأسلحة الغازية خلال الحرب العالمية الأولى، على توقيع اتفاقية «جينيف» لحظر استخدام “الغازات السامة والمسببة للاختناق..” و “أسلحة البكتيريا-البيولوجية…” لقتل الآخرين خلال النزاعات المسلحة في المستقبل. لم تكن تلك الاتفاقية جديدة بالكامل، فقد سبق الحرب العالمية الأولى، أن اتفقت بعض دول العالم على منع الحرب الكيميائية، واعتمدت بدلا من ذلك على الرصاص والقنابل والمدافع والسلاح التقليدي في حروبها.
قبل حدوث الحرب العالمية الثانية، وقعت عدة خروقات على تلك الاتفاقية، خصوصا على جهات لا تملك الإمكانية على مجاراة المقدرة العسكرية والنارية التقليدية للأطراف الأخرى. فقد استخدم الإسبان «غاز الخردل» خلال «حرب الريف»، وهي حركة تمرد بقيادة القبائل الأمازيغية في المغرب العربي. كذلك، فقد استخدمت اليابان «غاز الخردل» ضد الجماعات المتمردة في «تايوان»، فيما وجدت إيطاليا أن الأسلحة الغازية فعالة جدا في حربها مع أثيوبيا. فيما كان أول استخدام للولايات المتحدة الأمريكية للأسلحة البيولوجية خلال حرب فرنسا، عبر نشر غيوم غازية موبوءة بالجدري.
خلال الحرب العالمية الثانية، شجعت احتمالية استخدام الأسلحة الكيميائية الأطراف المتنازعة على تخزينها كنوع من التهديد باستخدامها كوسيلة للرد، فقد كانت هذه الأسلحة رادعا ضد الدولة القوية في ضرب الدول الضعيفة بأسلحة الدمار الشامل. وبغض النظر عن سياسية الأرض المحروقة التي اتبعتها جميع الأطراف المتنازعة الرئيسية خلال الحرب العالمية الثانية، فلم تستخدم الأسلحة الكيميائية على الإطلاق في تلك الحرب.
صحيح أن الأسلحة الكيميائية لم تستخدم خلال تلك الحرب، غير أن الدول لم تتوقف عن تطويرها وتحسين فعاليتها. فخلال النزاع، دفع الخوف من إمكانية تطوير القدرات الكيميائية، القوات العسكرية للحلفاء ودول المحور على استكشاف قدرات كيميائية جديدة وأكثر فتكا. مقادا بالذعر من ألمانيا، ضغط (وينستون تشيرشل) على دولته لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سبيل الدفاع ضد الغزو، ولتدمير مراكز القوى العاملة الألمانية. من هنا ظهرت الفكرة المفيدة جدا للأسلحة الكيميائية، تدمير وحدات العدو وقتل سكانه من دون تدمير البنية التحتية، وهي ميزة تلك الأسلحة ضد القنابل المدمرة والأسلحة النووية.

مع نهاية الحرب العالمية الثانية، صدم العلماء الأمريكيون والبريطانيون بمدى التقدم الذي حققه أقرانهم من الألمان في مجال تحسين الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، فقد طور العلماء الألمان مدافعاً قادرة على إيصال غاز السارين المركز، والتابون، وغازات الأعصاب الأخرى إلى أرض المعركة دون أن تتأثر قواتهم به. غير أن الخوف الأكبر كان ناجما عن معرفة القوات الغربية أن حليفهم في ذلك الوقت، الاتحاد السوفيتي- والذي بدأت العلاقات بالانهيار معه- قد امتلك ذات القدرة القتالية والتكنولوجيا البيولوجية.
طور الألمان عديد الطرق لإطلاق القنابل الكيميائية من مدافع وصواريخ وطائرات. حالما تطلق القنابل في الجو، تتكفل الرياح الشديدة في نشرها على مساحات واسعة. وفي الوقت الذي تبدأ فيه الغيمة السامة بالتوسع والانتشار، تبدأ درجة سميتها بالانخفاض تبعا لانخفاض مدى تركيزها. لم يتمكن العلماء الألمان من جمع بيانات كافية حول تأثيرات هذا الموضوع نتيجة انشغالهم بمحاربة الروس من جهة وقوات التحالف الغربي من جهة ثانية. لم يستثمر الألمان قدراتهم الكيميائية، فقد رفضت القيادة النازية استخدامها ضد القوات المعادية على الجبهتين الشرقية والغربية.
على الجانب الآخر، فقد استثمرت الولايات المتحدة وبريطانيا مبالغ هائلة في دراسة الإمكانيات الكبيرة لهذه الأسلحة، كان الاتحاد السوفيتي قد تفوق عليهم في امتلاكه وإطلاقه لهكذا قوة. أعاد الجيش الأمريكي تنظيم وحدات الأسلحة الكيميائية لديه على شكل «فيلق الأسلحة الكيميائية في الجيش الأمريكي»، وتغيرت مهمة هذا الفيلق من مجرد التصدي للهجمات الكيميائية إلى ضرب العدو بها. خلال الحرب مع كوريا، درس «فيلق الأسلحة الكيميائية» الطرق والسبل لاستخدام القنابل السامة في أرض المعركة ضد كوريا الشمالية، والصين، إضافة إلى القواعد والمدن السوفيتي. حقق الفيلق مراده عبر محاكاة الهجوم على مدن أمريكية لديها نفس الصفات الجغرافية والجوية والديموغرافية لدول العدو، ومن ضمن تلك المدن كانت مدينة «سانت لويس».

احتاج «فيلق الأسلحة الكيميائية» إلى استخدام مواد بديلة، غير ضارة، عواض عن السموم البيولوجية الحقيقية في تجربته، وذلك لنشرها في المدن الأمريكية، وقد وجد ضالته في «كبريتيد الونك-كادميوم». استخدم هذا المركب سابقاً في اختبار مشابه على طول الساحل في «كارولاينا الجنوبية» و«جورجيا». أضيف «الراديوم FP226» وهو مادة أعتقد أنها غير سمية، إلى مركب الكبريتيد، كي يتمكن الجيش من تتبع المواد المنشورة في الجو.
بدأت التجربة بنشر طائرات سلاح الجو الأمريكي من النوع «C-119» لمركب «كبريتيد الزنك». وبالفعل انتشر المركب في مدينة «سانت لويس» بواسطة مراوح مركبة على الأسطح وطوافات موجودة على الأرض. للحفاظ على هدوء السكان، أدعى الجيش أن البرنامج كان لاختبار “ستار دخاني” يتم تطويره لحماية «سانت لويس» من هجوم جوي محتمل. تم نشر كميات كبيرة من المادة ضمن مجمع «برويت إيجو» السكني، وهو مجمع سكني تم تشييده عام 1956. مثّل المجمع السكني، من حيث الكثافة السكانية فيه، نموذجا مشابها للمدن السوفيتية والألمانية المبنية حديثا، كما كان أكثر من 70% من القاطنين من الأطفال تحت سن الحادية عشر، وهو ما يشابه إلى حد كبير الطبيعة العمرية للمساكن السوفيتية.

لم يعلم أحد بهذه التجربة، لا السكان المحليون، ولا السلطات في «سانت لويس»، ولا الهيئات الصحية، ولا حتى أعضاء مجلس الشيوخ. تشير سجلات الجيش إلى أن بعض المواد وصلت إلى مسافة تزيد عن 65 كيلومتر نتيجة الرياح الشديدة أثناء التجربة. أقام الجيش الأمريكي تجربة ثانية، في الفترة بين عام 1963 و1965، وبنفس السرية المطلقة للتجربة الأولى. وكرر القائمون على التجربة أن الخليط المستخدم في التجربة الجديدة، كبريتيد الزنك، كان مادة غير ضارة، لكنهم لم يفصحوا عن استخدامهم لمادة FP226.
مع نهاية التسعينات من القرن الماضي، بدأت أعراض السرطان بالظهور على سكان مدينة «سانت لويس» بطريقة غير طبيعية، مما أثار انتباه الباحثين والمحللين المتخصصين. أنكر الجيش الأمريكي أي علاقة بالحادثة ونفى أن تكون المواد المستخدمة في تجربة الأسلحة الكيميائية هي مواد سامة، وواجه الجيش الأمريكي تساؤلات مجلس الشيوخ الأمريكي بضراوة.
منذ وقوع الحادثة، فقد ربطت العديد من الخيوط بين «كبريتيد الزنك» وحدوث العديد من الإصابات بالسرطانات، لكن جميع هذه الروابط لم تؤكد بشكل حاسم. لم يكن استخدام مواد مشعة ومسرطنة خلال الاختبار هو المشكلة الوحيدة التي سببها الجيش الأمريكي، فقد ترك «كبريتيد الزنك» العديد من الناس مع أمراض تنفسية مثل «داء الانسداد الرئوي المزمن» و «عضال الرئتين». ومع حلول عام 2012، لكن القيادات في الجيش الأمريكي بقيت على موقفها من عدم استخدامها ﻷيّ مواد ضارة خلال التجربة.
إضافة إلى ما سبق، أظهرت العديد من الأبحاث أن هناك العديد من السموم الأخرى التي استخدمت في تلك الواقعة، منها «سيراتيا ماركيسينس serratia marcescens، وهي بكتيريا مستشفيات تسبب العدوى، إضافة إلى محفزات المواد البيولوجية ومواد مسببة لاضطرابات المناعة.

بعد التجربة، ومع بداية السبعينيات من القرن الماضي، هجر السكان منطقة «برويت-إيجو»، والتي دُمرت لاحقا مع مرور السنوات. في نيسان من العام 2016 أعلنت وحدات الهندسة في الجيش الأمريكي تخليها عن موقع «برويت-إيجو» كمنطقة لإتمام مشروع مركز القيادة الغربي للـ «الوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية» NGA، لم توضح وحدات الهندسة السبب في هذا القرار على الرغم من وجود تقارير سابقة تفيد أنه كان الموقع الرئيسي للمشروع.
ادعت السلطات المحلية، بدعم من بعض المسؤولين الرسميين في «الوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية» أنه تم إسقاط الموقع من حسابات الوكالة لوجود بعض المواد السامة، والتي لوثت المكان. الادعاء يشير إلى وجود سموم من طبيعة «الأميانت» و «الرصاص»، غير أن تقارير متكررة، سواء محلية أو داخل أروقة الحكومة، تشير إلى نشاط إشعاعي في تلك المنطقة.
بقيت السجلات الرسمية للجيش الأمريكي حول اختبار «سانت لويس»، والمندرج تحت عملية «تغطية المنطقة الكبرى LAC، سرية. هذه السجلات حجبت خلفت ستار الأمن القومي، رغم مضي ستين عاماً على الحادثة. لكن من غير المشكوك فيه أن التجربة التي أقامها الجيش الأمريكي دون علم المواطنين خلفت العديد من الآثار المدمرة عليهم والتي ما زالوا يعانون منها حتى اليوم.


